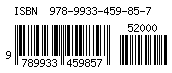تقريب الأسانيد و ترتيب المسانيد للإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي
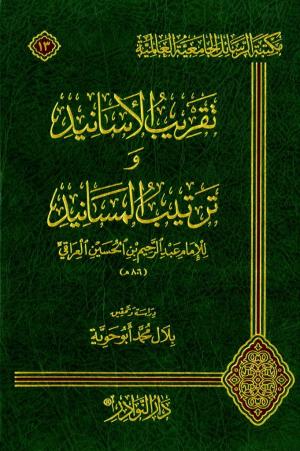
إن الحديث النبوي الشـريف يـتبوأ منـزلةً رفيعة عند المسلمين؛ ذاك لأنه المصدر الثاني من مصادر التشـريع، وهـو بمثابة البيان التفصيلي لنصوص القرآن وأحكامه.
قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[النحل: ٤٤].
ولهذا قَرن الحقُّ تـبارك وتعالى بين هذين المصدرين في كثيرٍ من آي الذكر الحكيم، معظماً شأنهما، منوهاً بفضلهما، موضحاً ومبيناً لهديهما.
فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].
والحكمة المذكورة في هذه الآية هي السُّنة كما قال علماء التفسير، وإذا كان الله تعالى قد تكفَّل بحفظ القرآن فلا يطرأ عليه تحريف ولا تبديل بنص قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[الحجر: ٩]، فمما لا شك فيه أن كلام النبوة داخلٌ في عموم هذا الوعد الإلهي، وهو محفوظٌ بحفظ الله من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
ونجد مصداقَ هذا الحفـظ الإلهي بأن هيَّأ الله لذلك رجالاً جعلهم وسـيلةً لإنجاز وعده، رجالاً ’نبَذوا الدنيـا بأسرهـا وراءهم، وجـعلوا غـذاءهم الكتابة، وسمرهم المعارضـة، واسترواحهم المذاكـرة، وخلوقَهم المداد، ونومهم السُّهاد، واصطلاءهم الضياء، وتوسُّدهم الحصى، فالشدائد مـع وجـود الأسانيـد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس، فعقولُهم بلذَاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلُّم السُّنن سرورهم، ومجالسُ العلم حُبُورهم، وأهلُ السنة قاطبةً إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم.
قومٌ آثروا المفاوز والقفار على التنعم في الدُّمن والأوطار، وتنعموا في البؤس في الأسفار مع مساكنةِ أهل العلم والأخبار، وقنَعوا عند جمع الأحاديث والآثار، بوجود الكِسر والأطمار‘.
رحم الله هؤلاء الرجال؛ لقد كانوا في الأمم معجزة العلم والتاريخ بما وضعوا من علوم، وأرسوا من قواعـد، وبما سَـنُّوا من قوانين، بل إن قوانين الرواية التي وضعوها هي أصح وأدق طريق علمي في نقل الروايات واختبارها.
ولم تعرف أمة من الأمم مثل هذه القـوانين، ولم تهتدِ إلى المنهاج العلمي الدقيق الذي طبَّقوه في تناولهم السنة، والحكم عليها والاستنباط منها والدفاع عنها.
وقد بلغ الاهتمام بإسناد الحديث مبلغاً عظيماً في نفوس المسلمين؛ لما يترتب عليه من معرفة الرجال الناقلين للحديث، ومراتبهم؛ ليتسنى الحكم على الحديث بالقوة أو بالضعف.
والسند ليس مجرد صفٍّ لأسماء الرواة واحـداً بعد واحد، وإنَّما هو إنجاز عقلي غاية في الدقة، ترتَّب عليه علم قائم على أدق منهج عرفه التاريخ، وهو علم مصطلح الحديث بفروعه المختلفة.
ومن أجلِّ فروعه التي كانت وليدة الإسناد: علم الجرح والتعديل، الذي يميز الرواة المقبول حديثهم من غيرهم.
قال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في معرض حديثه عن السند:
’ولا يعنون حدَّثني فلان عن فلان مجرداً، بل يريـدون ذلك لما تضمَّنه من معرفة الرجال الذين يُحدَّث عنهم؛ حتى لا يُسند عن مجهول ولا مجروح ولا متَّهم، إلا عمَّن تحصل الثقة بروايته؛ لأنَّ روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أنَّ الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لنعتمد عليه في الشريعة، ونسند إليه الأحكام‘.
وبهذا أصبح الإسناد للحـديث مثل الأساس للبناء، واستقر في الأذهان أنه لا يمكن تصـور الحديث بـدون الإسـناد، كما لا يمكن أن يُتصـور البنيان بـدون الأساس، والجسم بدون الروح؛ فأصبح الحديث عبارة عن جزأين: الإسناد والمتن، والحديث الذي ليس له سند ليس بشيء، ولذلك اشتهر بين المحدثين: أن السند للخبر كالنسب للمرء.
قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[النحل: ٤٤].
ولهذا قَرن الحقُّ تـبارك وتعالى بين هذين المصدرين في كثيرٍ من آي الذكر الحكيم، معظماً شأنهما، منوهاً بفضلهما، موضحاً ومبيناً لهديهما.
فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].
والحكمة المذكورة في هذه الآية هي السُّنة كما قال علماء التفسير، وإذا كان الله تعالى قد تكفَّل بحفظ القرآن فلا يطرأ عليه تحريف ولا تبديل بنص قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[الحجر: ٩]، فمما لا شك فيه أن كلام النبوة داخلٌ في عموم هذا الوعد الإلهي، وهو محفوظٌ بحفظ الله من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
ونجد مصداقَ هذا الحفـظ الإلهي بأن هيَّأ الله لذلك رجالاً جعلهم وسـيلةً لإنجاز وعده، رجالاً ’نبَذوا الدنيـا بأسرهـا وراءهم، وجـعلوا غـذاءهم الكتابة، وسمرهم المعارضـة، واسترواحهم المذاكـرة، وخلوقَهم المداد، ونومهم السُّهاد، واصطلاءهم الضياء، وتوسُّدهم الحصى، فالشدائد مـع وجـود الأسانيـد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس، فعقولُهم بلذَاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلُّم السُّنن سرورهم، ومجالسُ العلم حُبُورهم، وأهلُ السنة قاطبةً إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم.
قومٌ آثروا المفاوز والقفار على التنعم في الدُّمن والأوطار، وتنعموا في البؤس في الأسفار مع مساكنةِ أهل العلم والأخبار، وقنَعوا عند جمع الأحاديث والآثار، بوجود الكِسر والأطمار‘.
رحم الله هؤلاء الرجال؛ لقد كانوا في الأمم معجزة العلم والتاريخ بما وضعوا من علوم، وأرسوا من قواعـد، وبما سَـنُّوا من قوانين، بل إن قوانين الرواية التي وضعوها هي أصح وأدق طريق علمي في نقل الروايات واختبارها.
ولم تعرف أمة من الأمم مثل هذه القـوانين، ولم تهتدِ إلى المنهاج العلمي الدقيق الذي طبَّقوه في تناولهم السنة، والحكم عليها والاستنباط منها والدفاع عنها.
وقد بلغ الاهتمام بإسناد الحديث مبلغاً عظيماً في نفوس المسلمين؛ لما يترتب عليه من معرفة الرجال الناقلين للحديث، ومراتبهم؛ ليتسنى الحكم على الحديث بالقوة أو بالضعف.
والسند ليس مجرد صفٍّ لأسماء الرواة واحـداً بعد واحد، وإنَّما هو إنجاز عقلي غاية في الدقة، ترتَّب عليه علم قائم على أدق منهج عرفه التاريخ، وهو علم مصطلح الحديث بفروعه المختلفة.
ومن أجلِّ فروعه التي كانت وليدة الإسناد: علم الجرح والتعديل، الذي يميز الرواة المقبول حديثهم من غيرهم.
قال الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في معرض حديثه عن السند:
’ولا يعنون حدَّثني فلان عن فلان مجرداً، بل يريـدون ذلك لما تضمَّنه من معرفة الرجال الذين يُحدَّث عنهم؛ حتى لا يُسند عن مجهول ولا مجروح ولا متَّهم، إلا عمَّن تحصل الثقة بروايته؛ لأنَّ روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أنَّ الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لنعتمد عليه في الشريعة، ونسند إليه الأحكام‘.
وبهذا أصبح الإسناد للحـديث مثل الأساس للبناء، واستقر في الأذهان أنه لا يمكن تصـور الحديث بـدون الإسـناد، كما لا يمكن أن يُتصـور البنيان بـدون الأساس، والجسم بدون الروح؛ فأصبح الحديث عبارة عن جزأين: الإسناد والمتن، والحديث الذي ليس له سند ليس بشيء، ولذلك اشتهر بين المحدثين: أن السند للخبر كالنسب للمرء.
| المجموعة | مكتبة الرسائل الجامعية العالمية |
| الناشر | دار النوادر |
| عنوان الناشر | دمشق |
| سنة النشر (هجري) | 1433 |
| سنة النشر (ميلادي) | 2012 |
| رقم الطبعة | 1 |
| نوع الورق | كريم شاموا |
| غراماج الورق | 70 |
| قياس الورق | 17 × 24 |
| عدد المجلدات | 1 |
| عدد الصفحات | 806 |
| الغلاف | فني |
| ردمك | 9789933459857 |
| تأليف/تحقيق | تحقيق |
| تصنيف ديوي |
تحميل
كلمات مفتاحية
روابط مفيدة